1
في البدء كانت الكلمة… لكن يبدو أن بعض الكتّاب لم يُطربْهم هذا الافتتاح المقدّس، فانتفضوا عليه كما ينتفض ممثل مبتدئ على نصّ شكسبيري بحجّة أنه “لا يشعرُ به”. قرّروا أن يُعيدوا كتابة أنفسهم، لا بل ترجمة ذواتهم إلى لغة أخرى، كأنهم ممثلون في فيلم فنّي ممل، يصرّ مخرجه على إعادة تصوير المشهد الأول خمس عشرة مرة لأن شعاع الشمس لم يسقط على الكتفين بزاوية “كونية كافية”. هؤلاء الكتّاب لا يغيّرون اللغة بحثًا عن الدقة أو الغواية، بل لأنهم يشتبهون في أن اللغة الأصلية تنتمي لعالم لم يعد يعبّر عنهم، أو ربما لأنها لم تعد تضمن لهم جائزة أدبية في دولة غائمة شمال الأطلسي.
2
هؤلاء الكبار الذين تُدرّس كتبهم في الجامعات كأنها أناجيل العصر الحديث، ويُقتبس كلامهم في ورشات تطوير الذات على إنستغرام وسط ورود اصطناعية، قرروا – بكل ما أوتوا من شجاعة شاعر وارتباك مترجم مبتدئ – أن يهجروا لغتهم الأم. نعم، هجروها كما يُهجر بيت الطفولة: بكثير من التبرير وقليل من الحنين. كتبوا بلغة الآخر. وأيّ آخر؟ لا يهم. قد يكون الآخر أكثر أناقة، أو أكثر قدرة على التسلل إلى رفوف المكتبات الأوروبية، أو ببساطة، أكثر قابلية للتمويل. المهم أنه “آخر”، يحمل جواز سفر لغويًا غير مهدد بالانقراض، ويُفتح له باب الجوائز والتكريمات دون الحاجة لشرح السياق الثقافي في الهامش.
3
خذ مثلًا: صامويل بيكيت، الأيرلندي الذي قرر أن يكتب بالفرنسية، لا افتتانًا بسحر موليير، بل – حسب زعمه المدهش – لأن “الفرنسية تسمح له بأن يكتب دون أسلوب”. تخيّل أن تهجر لغتك الأم فقط لأنك تجيدها أكثر من اللازم! كأنك تتوقف عن العزف على البيانو لأن أصابعك أصبحت بارعة جدًا، وصارت الموسيقى تنساب “بجمال مريب”. بيكيت، بتقشف ناسك ومزاج فيلسوف ضجر، أراد أن ينجو من غواية اللغة، من زينة البلاغة، من فخاخ الأناقة، فكتب بلغة لا تتوسّل ولا تغوي. والنتيجة؟ نصوص كئيبة، متقشفة، عظيمة، كأنها صوامع فكرية بلا نوافذ، كتبها رجل يخشى أن تسرق الجملةُ منه المعنى، أو أن يبتسم القارئ في لحظة غير مأذون بها.
4
ثم لدينا فلاديمير نابوكوف، الرجل الذي قرر أن يتحدث عن الفراشات والمحظورات بلغة إنجليزية، بعد أن كانت الروسية تفيض بين أصابعه. كتب نابوكوف رواياته وكأنما يعزف على آلة مستعارة، لكنَّه أصرّ على ألا يجرؤ أحد على تصحيح نغماته. وكان فخورًا جدًا بذلك. قال مرة إن أحد المراجعين الإنجليز شطب له كلمة لأنه ظنها خطأ نحويًا، فرد نابوكوف”: أنا من كتب هذه الكلمة، إذًا فهي صحيحة”؛ الغطرسة اللغوية حين تصل إلى هذه الدرجة، تصبح فنًا.
5
ولا ننسى جوزيف كونراد، البولندي الذي كتب بالإنجليزية رغم أنها لغته الثالثة، أو ربما الرابعة، بعد أن أمضى نصف حياته على السفن والنصف الآخر في قلق لغوي دائم. كان يكتب كمن يبحر بمفردات استعيرت من القبطان. قال كونراد مرة إن اللغة الإنجليزية “تحرم الكاتب من التنفس الطبيعي”، وهذا حقيقي إذا كنت تتعلمها بعد سن الثلاثين وأنت تطارد الحيتان.
لا يزال بعض النقاد مذهولين من أن جوزيف كونراد كتب” قلب الظلام” بلغة لم يبدأ التحدث بها إلا بعد سن الحادية والعشرين. أما نحن، فبالكاد نحسن تركيب جملة مفيدة بلغتنا الأم… حتى بعد التخرّج من الجامعة.
6
ثم لدينا إليف شافاق، الكاتبة التركية التي تتنقّل بين التركية والإنجليزية كما يتنقّل دبلوماسي محنّك بين الموائد، بسلاسة مصقولة أو بتوتر محسوب بعناية، وفقًا لنوع الجمهور الذي ترغب في إيقاظ شعوره بالذنب الثقافي. لا تكتب شافاق بلغة الآخر فحسب، بل تعْقد بها الندوات، وتوزّع بها الإضاءات الكاشفة على “التعقيدات الشرقية” كما تسميها.
تستخدم الإنجليزية كما يستخدم ساحر أدواته: لتُبهرك لا لتقنعك. تُنمّق، تُفسّر، تُبسّط، ثم تترك القارئ الغربي، بعد كل فصل، وهو يحدّق في سقف غرفته، شاعرًا بأنه مسؤول شخصيًا عن انهيار الإمبراطورية العثمانية، أو على الأقل عن سوء فهمه لقيم الحريم. إنها لا تترجم الشرق، بل تؤطره، كتحفة غريبة في صالون عالمي، يقال عنها: كم هو معقدٌ هذا الشرق… وكم نحن محظوظون أن شافاق تشرحه لنا بلغة نُجيدها أكثر من اللازم.
7
أما رضوى عاشور، فقد كتبت بالإنجليزية أيضًا، بلغة المستعمر، لغةٍ لم تأتِها وادعةً منفتحة، بل محمّلة بتاريخ من الهيمنة والسرديات المفروضة. ومع ذلك، كتبت بها عن النكبة، والمقاومة، والتاريخ المسروق. أن تكتب عن النكبة بلغة الاحتلال التاريخي… تلك مفارقة لا يملك النقاد أدواتها الكافية، لأنها تتجاوز التحليل إلى حقل التأويل الشعري. كأن اللغة ذاتها تتحوّل إلى مسرح للمواجهة، أو إلى وسيلة لاختراق الحصن من داخله، لا للانتماء إليه، بل لإعادة ترسيمه بحبر الغائبين والمنفيين.
8
وهناك إدوارد سعيد، الذي استخدم الإنجليزية كمن يُحمّل الخشب المعتاد أثقالًا غير مألوفة: نظرية مشتبكة، ونقدًا لاذعًا، ووجعًا لا يسعفه الحياد الأكاديمي. كتب بها كما يُعيد مهندسٌ بناء بيتٍ شارف على الانهيار: من الداخل، بحذر، وبصرامة.
والمفارقة أن سعيد، رغم سيادته الكاملة على اللغة، ظلّ يشعر أن شيئًا ما قد يفلت، أن الكلمة قد تتواطأ مع الخصم في لحظة حرجة. لم يكن يخشاها لضعفه، بل كان يهابُها لقوّتها—لقابليتها الدائمة لإعادة التشكّل، وربما لإعادة الخيانة.
9
لنتوقف لحظة عند إيمي سيزار، الشاعر المارتينيكي الذي كتب بالفرنسية عن استعمار فرنسي. تخيّل أن تكتب قصيدة غاضبة عن جلادك، ثم ترسلها إليه بلُغته، مصوغة بأناقة شعرية تعجزه، كأنك تسلمه تقريرًا مفصّلًا بجرائمه، مكتوبًا بحروفه هو. سيزار لم يستعِر الفرنسية، بل فكّكها وأعاد صهرها لتكون لغةً مذعورة أمام حقيقتها، ومنفية عن براءتها، فكانت قصيدته فعل مقاومة، وإدانة تُتلى على مسرح اللغة ذاتها. سيزار كتب بلغة الآخر كمَن يستعيرُ سلاحًا من خصمه ليكسره عليه؛ هكذا وُلد “خطاب عن الاستعمار Discours sur le colonialisme”، وثيقة تُقرأ كما يُقرأ تقرير الطب الشرعي، مكتوبة بلغة الجريمة ذاتها، لا لتُخفِي أثرها، بل لتفضحه من الداخل، بندًا بندًا، وجُرحًا جُرحًا.
10
أما ياسين الخليل، المعروف بـ “طارق علي”، الكاتب البريطاني-الباكستاني، فقد قرر منذ البداية أن يكتب بالإنجليزية، لا لأن البنجابية ضيقة، بل لأن الإنجليزية سريعة الانتشار… خاصة إذا كانت مليئة بالثورة، والغضب اليساري، وبعض الفكاهة اللندنية. طارق علي لا يحتاج إلى أن يترجم نفسه، فهو في حدّ ذاته ترجمة نابضة للتعدد الثقافي؛ يفكك الإمبريالية البريطانية بلغة شكسبير، ويشرح الماركسية لأحفاد تاتشر، كل ذلك بلغة الآخر التي لم تعد مجرد وسيلة، بل صارت مكوّنًا من هويته.
11
ثم لدينا أندريه ماكين، الفرنسي الروسي، الذي كتب رواياته الأولى بالفرنسية، وقال للناشرين إنها مترجمة من الروسية… حتى يصدّقوا أنها عميقة! كانت هذه أول خدعة لغوية في سوق النشر الفرنسي الحديث. لجأ ماكين إلى التنكر اللغوي ليقنع النقّاد بأنه كاتب جاد، ثقيل الظل كما يحبّون، وأن حزنه الروائي ليس مستوردًا من كسل مقاهي باريس، وإنما من صقيع سيبيريا القارس. وهكذا قُبل في ناديهم المغلق، بعدما ارتدى معطف الآخر وتخلّى طوعًا عن بطاقة هويته.
12
وبعيدًا عن أوروبا، دعنا نلتفت إلى تشيغوزي أوبيوما، الكاتب النيجيري الذي يكتب بالإنجليزية… رغم أن أمه لا تستطيع قراءة رواياته. تخيّل أن تنشر كتابًا عالميًا، فتقول لك والدتك: “هل طبعوه بلغة نيجيرية أم بلغة الأجانب؟” في إحدى المقابلات، قال أوبيوما إنه يشعر بالانقسام حين يكتب: “أكتب للغريب بلغته، لكنني أسمع أصوات شخصياتي بلغة اليوروبا”. باختصار، هو يكتب رواياته كمن يدبلج فيلمًا على عجل.
13
لو عدنا إلى العربية، سنجد من كتب بالفرنسية كما لو كانت وطنه الأول، مثل الطاهر بن جلون، الذي ما زال، بعد عقود من الكتابة، يتعامل مع الفرنسية كما يتعامل مغربي خجول مع لغة أجنبية في السوق: بكثير من الحذر، وبقدر لا يُستهان به من البراعة المرتبكة. لم يتخلَّ بن جلون عن العربية، لكنه اختار الفرنسية ليكتب عن الاغتراب، لأن الحديث عن الغربة من قلب اللغة الأم يشبه الشكوى من البرد تحت لحاف دافئ. فكتب عن المغرب بلهجة باريس، وشرح الشرق على أرصفة الغرب، كمن يترجم نفسه على أمل أن يفهمه الآخر… أو على الأقل، أن يُصدّقه.
15
حتى بول أوستر، الأميركي الذي يكتب بالإنجليزية بثقة من اعتاد أن يفك ألغاز الحياة بقلم حبر فاخر، اعترف – في لحظة صدق نادرة وربما زلّة لغوية مدروسة – أن الترجمة الفرنسية لرواياته تجعله يبدو “أكثر ثقافة مما هو عليه فعلاً”. تخيّل! كأن يقول أحدهم: “أنا لا أبدو ذكيًا، فقط هناك من ترجمني بذكاء”. اعتراف كهذا لا يصدر عادة عن كتّاب أميركا، إلا إذا كانوا قد تناولوا فطورهم في مقهى باريسي وشعروا أن قبعتهم تناسبت فجأة مع الفكر الوجودي.
الفرنسية، على ما يبدو، لا تكتفي بترجمة النص، بل تعيد تأهيله. تغسله، تكويه، وتقدّمه على مائدة أنيقة محاطًا بنصوص بودلير وهيغو، حتى لو كان أصله قد كُتب في مترو بروكلين. إن مرور الكاتب عبر القنوات اللغوية الرفيعة للفرنسية يشبه دخول معطف رثّ إلى محلّ خياطة باريسية: يخرج منه قطعة فنية تُعرض في متحف، وتُقرأ بصوت منخفض مع انحناءة خفيفة للرأس.
16
بل إن بعض الكتّاب عمدوا إلى تغيير شخصياتهم الأدبية بالكامل عندما يكتبون بلغة أخرى. خذ مثلاً إيزابيل الليندي الشيلية، التي تكتب بالإسبانية، لكنها تترجم أعمالها بنفسها إلى الإنجليزية، مع إضافة “لمسات” من التعديل لتناسب ذوق القارئ الأمريكي. هنا، الترجمة ليست خيانة للغة الأصلية، بل هي فن العلاقات العامة؛ إنها عملية إعادة صياغة الهوية الأدبية لتناسب معايير السوق، كما لو كانت عملية تجميل أدبي.
17
الترجمة، بلغة الآخر، تصنع معجزات: تُجمّل النص، تُعقّد البسيط، أو تُبسّط المعقد. وفي بعض الأحيان، تجعل كاتبًا مجهولًا يبدو عبقريًا… لأن القارئ الغربي يظن أن أي نصٍ قادم من الشرق يحمل بالضرورة حكمةً بوذية. بعض النقاد يسألون: هل يفكر الكاتب بلغة الآخر؟ الجواب يتغير حسب مزاج الكاتب: في الصباح، قد يشعر أنه يكتب بروح مزدوجة، تتنقل بين لغتين. أما في المساء، فقد يشعر أنه موظف في سفارة أدبية، يتقاضى راتبه من الكلمات، ويؤدي واجبه بكل مهنية… دون أن يجرؤ على أن يسرح بخياله.
18
لكن الخطر الحقيقي ليس في استعمال اللغة الأخرى، بل في أن يقع الكاتب في حبائلها، ويبدأ بالتفكير على طريقتها، كما لو كانت هي من يكتب وهو مجرّد سكرتير. عندها لا يعود ناقدًا، بل شريكًا في الجريمة. لا يصبح كاتبًا مهاجرًا، بل مقيماً مريحًا في حيٍّ لغويٍّ بورجوازي، حيث الكلمات مصقولة لكنها بلا طَعم، مؤدبة لكنها بلا حرارة. وإذا كانت اللغات، كما قال فيلسوف ساخر، تشبه العشّاق القدامى، فإن الكاتب بلغة الآخر لا يصبح كاتبًا مهاجرًا، بل مقيماً مريحًا في حيٍّ لغويٍّ بورجوازي، حيث الكلمات أنيقة مثل أثاث فاخر في صالة استقبال… تلمع كثيرًا، لكنها غير صالحة للجلوس طويلًا.
والحق يُقال، كثير من الكتّاب الذين كتبوا بلغة الآخر لم يفعلوا ذلك حبًّا في الآخر، بل لأن لغتهم الأم كانت، في ذلك الحين، مكمّمة أو مشلولة أو ترتجف من ظلّها. لم يكن الخيار رومانسيًا، بل اضطراريًا. في بعض تجارب الشتات، تكون اللغة الأخرى أشبه بقارب نجاة؛ لا لأنك تحب الإبحار، بل لأن اليابسة تحتك انهارت. لكن القوارب ليست دائمًا كريمة، فقد تظل تدوّرك في البحر، ثم تلقي بك على جزيرة معزولة… بلا مفردات، وبلا أعلام لغوية يمكنك رفعها لتقول: “أنا هنا”.
19
سؤال: هل خان هؤلاء الكتّاب لغتهم الأم؟ أم أنهم اختاروا أن يرووا حكايتهم من شرفة لغةٍ أخرى، أوسع أفقًا وأقل ضجيجًا؟
جواب: لا أحد يملك يقينًا. ما نعرفه هو أنهم وسّعوا، بلا شك، دائرة إحباط المترجمين؛ أولئك الذين يُكلّفون بإعادة النص إلى “أصله”، فيكتشفون أن الأصل مراوغ، زئبقي، يشبه طيفًا لغويًا لا يمسك ولا يُعاد. وكأنهم يُطلب منهم أن يزرعوا شجرة في الهواء، ثم يُسألون لاحقًا: لماذا لم تثمر؟
20
في النهاية، الكتابة بلغة الآخر لا تُثبت عبقرية الكاتب أو صبره، بل هي أشبه بشخص يعزف على آلة موسيقية مستعارة أمام جمهور ونقّاد يتربصون به في كل خطوة، كما لو كان مطلوبًا منه أن يعزف سيمفونية وهو يحاول ألا يُفسد النغمات.
الكتابة بلغة الآخر تظل مغامرة محفوفة بالنجاة والفقدان، كما لو أنك تمشي على جسر متهالك فوق نهر متلاطم، لا تدري إن كنت ستصل إلى الضفة الأخرى أو ستغرق في منتصف الطريق. هي مغامرة لا يجرؤ عليها إلا من فقد صوته بلغته الأم، وقرر أن يخوضها بلغة غريبة، على أمل أن يعزف لحنًا لم يُسمع من قبل، لكن على الأقل… لا أحد يستطيع أن يسرق منه لحنه الضائع.
21
لذا، نرفع القبعة لهؤلاء الكتّاب: لقد خاطروا، ارتبكوا، كتبوا، وتُرجِموا… ثم قرأناهم ونحن نقول: الله! ما أجمل ما قاله!… ثم نكتشف أنهم قالوه بلغة ليست لغتهم، ونحن فهمناه بلغة ليست لغتنا… لكننا، رغم ذلك، تأثرنا.
في النهاية، قد تبدو الكتابة بلغة الآخر مثل حضورك لحفل زفاف لا تعرف فيه العريس ولا العروس، لكنك ترتدي بذلة فاخرة، وتبتسم في الصور. أنت هناك، تُمثّل نفسك، وتحاول ألّا تسيء استخدام أدوات المائدة اللغوية.
22
فإذا نجحت، قالوا: “ما أعمقه!”
وإذا أخفقت، قالوا: “مسكين، هذه ليست لغته.”
هكذا يُمنح الكاتب بلغة الآخر امتيازًا فريدًا: يُحتفى به في النجاح، ويُعذَر عند الفشل. مثل طفل يُطبل في عرس، والجميع منبهر لأنه لم يسقط الطبل على رأسه.
فيا أيها الكُتّاب المجازفون، أيها الحالمون بالكتابة في حديقة الآخر، تذكروا: اللغة ليست فقط وسيلة للتعبير، بل أيضًا وسيلة للضياع الأنيق. وإذا تهت فيها، تظاهر أنك تعرف الطريق… واكتب عن التيه بلغة التيه نفسها. في أسوأ الأحوال، قد يظنّك أحدهم شخصًا عميقًا للغاية، لدرجة أن عدم فهمنا لك يُعتبر بديهيًا، فنحن ببساطة لا نملك القدرة على ملاحقة “عظمتك الفكرية”.
23
وفي اللحظة التي يُمسك فيها الكاتب بلغة الآخر، ويدوّن بها فكرةً عن الوطن، أو الحنين، أو عن جدته التي لا تعرف القراءة، يصبح كمن يحاول إقناع سمكة بأن الماء رطب. تجربة عبثية، فلسفية، مضحكة بقدر ما هي موجعة: يتكلم ليُفهم، لكنه يُترجم ليُحتمَل. يتألم بلغتين، ويضحك بثالثة. وبينما هو يبحث عن جملة تُنقذه، يكتشف أن اللغة – أيّ لغة – لا تُنقذ أحدًا، لكنها تمنحك لحظة وجيزة لتبدو كأنك تفهم ما يحدث… ثم تمرّ الجملة، وتمرّ الحياة، ويبقى السؤال الأهم: هل تكتب بلغة الآخر لتتجاوز حدودك، أم فقط لأن الآخر يملك طابعة أفضل؟
لنتأمل؛ وإلى حديث آخر.


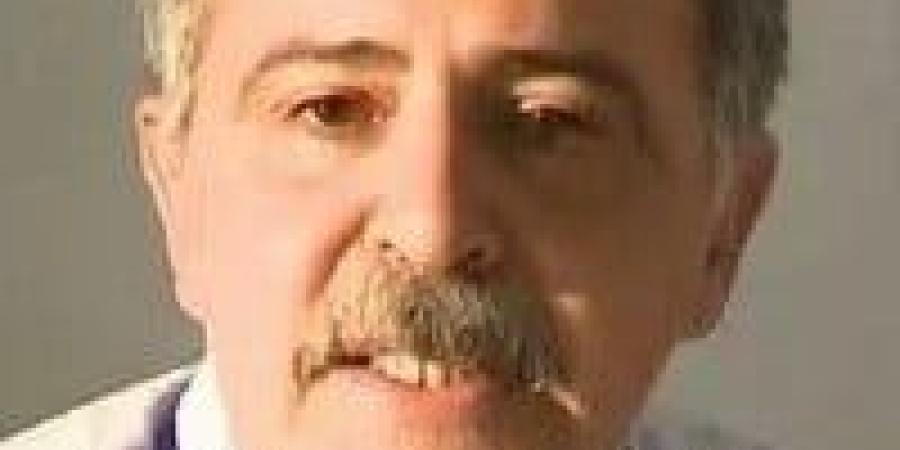




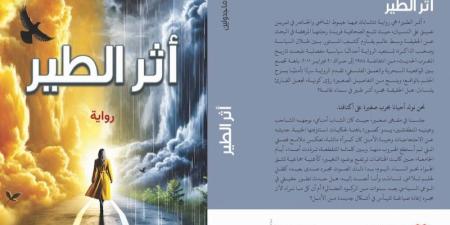
0 تعليق